أرشيف الفتاوى
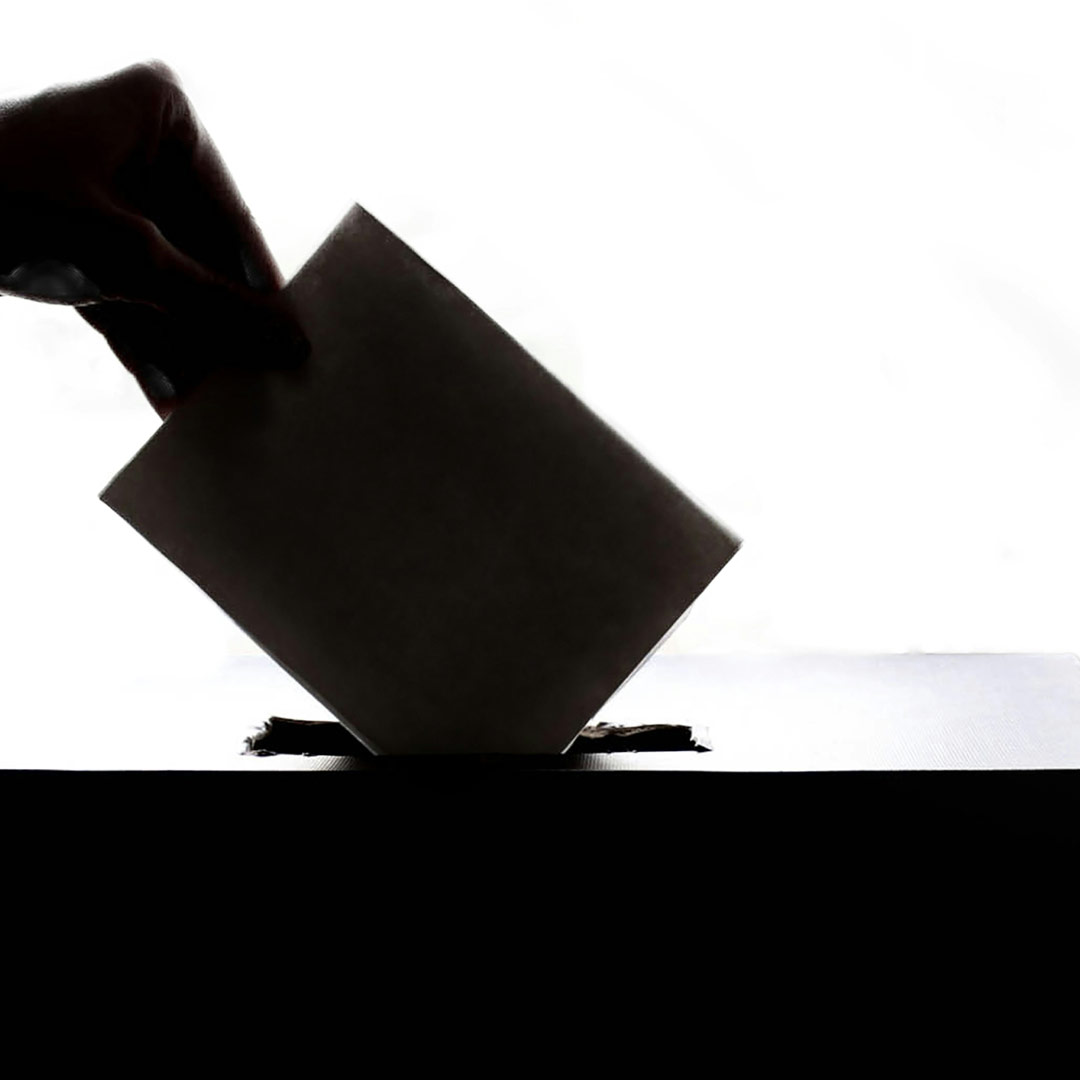

تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم
ووجهتهم في ذلك أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم في هذا العصر من المحرمات، واعتبروا أن فاعلها قد لا يسلم من الكفر.
ويستند المتشددون في تحريمهم للتهنئة إلى الأدلة التالية:
تفسيرهم لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان:72] قال القاسمي في تفسيره: «قال المبرد في (الكامل): ويُروى عن ابن عباس في هذه الآية (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان:72] قال: أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور: الغناء. فقيل لابن عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ فقال: لا، إنما آية شهادة الزور (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا) [الإسراء:36]»([1]). وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا الأشج، أخبرنا عبد الرحمن بن سعيد الخراز، ثنا الحسين بن عقيل، عن الضحاك: (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان:72] قال: عيد المشركين. ورُوي عن أبي العالية، وطاووس، والربيع بن أنس، والمثنى بن الصباح نحو ذلك([2]).
روى الإمام البيهقي عن سيدنا عمر- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم»([3]).
ما نقله الشيخ ابن القيم من اتفاق العلماء على تحريم التهنئة، وهذا نصُّه:
«وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصَّة به فحرام بالاتفاق؛ مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلِم قائله من الكفر فهو من المحرَّمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنَّأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرَّض لمقت الله وسخطه»([4]).
نكتفي الآن بما ذكرنا لأنه عمدة لكل القائلين بتحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم، وما عدا هذه الخطوط الرئيسة هي بمثابة تكرار لهذه الأقوال.
ثالثًا: مناقشة هذه الأدلة والرد عليها.
- تفسيرهم لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [الفرقان:72] حيث أوهموا العوام أن التفسير الأوحد لها أن المراد بها أعياد المشركين؛ ولكن هذا الحكم المطلق لا يصح بحال، وذلك من وجوه:
أغلب المفسرين لم يذكروا هذا القول، ولم يشيروا إليه وعلى رأسهم الإمام الطبري، والإمام القشيري، والإمام ابن عطية، والإمام الواحدي، والإمام الفخر الرازي، والإمام النسفي، والإمام البيضاوي، والجلالين، والإمام ابن عجيبة، والإمام الشوكاني([5])، وغيرهم الكثير.
المفسرون الذين أوردوه في كتبهم صدروه بقولهم: «قيل» للدلالة على ضعف هذا الرأي وهو ما فعله الإمام الخازن والإمام أبو حيان الأندلسي والإمام السمعاني، وسبقهم جميعًا الإمام المبرِّد فنقل في كتابه: «الكامل» هذا الرأي مع تصديره بـ: «يُروى» المبني للمجهول للدلالة على ضعف هذا القول([6]).
ذكر المفسرون هنا في معنى الزور ما يربو على عشرين معنى نذكر منها شيئًا:
فمنها أنه يطلق على صنم كان بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام، وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا مروا به مروا كرامًا لا ينظرون إليه. ومنها أنه الشرك. ومنها أن معنى الآية أنهم لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا يمالؤنهم فيه. ومنها مجالس السوء. ومنها لعب كان في الجاهلية. ومنها الغناء واللهو. ومنها مجلس كان يُشتم فيه النبي ﷺ. ومنها قولهم لآلهتهم وتعظيمهم إياها ما كانوا فيه من الباطل([7])، وغير ذلك من التفسيرات فلماذا هجروها، واختاروا القول بعدم شهود أعياد غير المسلمين وبنوا حكمًا شرعيًّا على أساسه؟
يحسم الأمر كلام الإمام الطبري في تفسيره بعد أن عرض كل الأقوال الواردة في المسألة فقال:
«وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء؛ لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضًا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فإذا كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل لا شركًا ولا غناء ولا كذبًا ولا غيره، وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور؛ فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل»([8]).
وعلى فرض أننا سلمنا جدلًا بصحة هذا التفسير، وتناسينا الأئمة الذين أهملوه أو ضعفوه، وأسقطنا جميع الآراء الأخرى ما الذي سيتغير!
إن كلامنا عن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وليس عن حضور المسلمين لهذه الأعياد، فهذا استدلال في غير موضعه.
- كما استدلوا أيضًا بالأثر الوارد عن سيدنا عمر- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم»([9]). ويرد على هذا الدليل من وجوه:
أولًا بالنظر إلى سنده: فقد رواه عبد الرزَّاق في مصنفه بسنده عن الثوري عن عطاء ابن دينار موقوفًا عليه ولم يرفعه إلى سيدنا عمر، فكأن الأثر من قول عطاء وليس من قول سيدنا عمر حيث لم يُذكر أبدًا، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور عن عطاء موقوفًا عليه أيضًا، وعلى هذا فليس للأثر كل هذا الزخم الذي يزعمون؛ خاصة وأن ثور بن يزيد كان يقول بالقدر، قال الإمام أحمد بن حنبل: كان ثور يرى القدر، وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه. وكان الإمام الأوزاعي سيء القول في ثور([10]).
وحده الإمام البيهقي في السنن الكبرى أسند الحديث إلى سيدنا عمر؛ ولكن عن طريق ثور بن يزيد أيضًا، فليس السند شديد القوة كما يلبسون على غير المتخصصين.
ليس في هذا الأثر أيضًا أي دليل على تحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم؛ إنما هو نهي عن رطانة الأعاجم ودخول الكنائس يوم العيد، ومعنى رطانة الأعاجم كما في لسان العرب: «رطن العجمي يرطن رطنًا تكلم بلغته... وهو كلام لا يفهمه العرب»([11]).
وبذلك يتضح أن هذا الأثر أيضًا ساقط الحجية، ولا يصلح في تدعيم قولهم.
- وأخيرًا نقف على كلام الشيخ ابن القيم والذي مفاده أن من هنَّأ غير مسلم بعيده إن سلم من الكفر فإنه قد ارتكب حرامًا، وزعم أن الحكم متفق عليه، ويناقش بما يلي:
هذه مسألة لا تخضع بحال للعقائد فهي مسألة فقهية بحتة، وإننا نتساءل كيف زجَّ بها الشيخ ابن القيم- رحمه الله- في باب العقائد، وجعل فاعلها بين طامتين: الكفر أو ارتكاب الحرام، وهي مسألة من الفروع لا الأصول؟
هذا الكلام يتعارض مع قول الله تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين) [الممتحنة:8] يقول الإمام النسفي في تفسيرها: تكرموهم وتحسنوا إليهم قولًا وفعلًا... (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) وتقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم، وإذا نهى عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم (ِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين)([12]). وكلام الإمام النسفي لا يجاوز معنى البر الذي أمرنا الله به، قال سيدنا ابن عمر: «البر شيء هين وجه طليق، و كلام لين»([13]).
نقل ابن القيم الاتفاق على تحريم التهنئة وهذا غير مسلم به، فالإمام المرداوي رحمه الله نصَّ على الخلاف في المسألة حيث قال: «وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان: وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والشرح، والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا، إحداهما: يحرم وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، وقدَّمه في الفروع. والرواية الثانية: لا يحرم فيكره وقدَّمه في الرعاية، والحاويين في باب الجنائز ولم يذكر رواية التحريم. وذكر في الرعايتين والحاويين رواية بعدم الكراهة فيباح، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وعنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدين، ومعناه: اختيار الآجري وأن قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام، قلت: هذا هو الصواب، وقد عاد النبي ﷺ صبيًّا يهوديًّا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، نقل أبو داود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم([14]).
وقال ابن مفلح: «وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان»([15]) ووافقه عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني في المحرر([16]).
رابعًا: حكم تهنئة غير المسلمين بعيدهم
ذهب العلماء المعاصرون إلى أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بعيدهم وهو ما قرَّره علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ودار الإفتاء الأردنية([17]).
وقبل أن نعدِّد الأدلة التي تؤيد جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ننبه على أمرين:
الأول: هناك فرق بين غير المسلمين المسالمين الذين لا يصل إلينا منهم شر وبين المحاربين المعتدين، فالمحاربون يحرم تهنئتهم لأنهم يريدون أن يغيروا علينا، أما المسالمون الذين يعيشون بيننا فهم الذين قصدناهم بهذا البحث.
الثاني: أننا نفرق بين التهنئة بالعيد وبين الإقرار بعقائد مغايرة لدين الإسلام والرضا بها، فلا يوجد مسلم سيبدل دينه من أجل التهنئة، وإنما نفرق بين التهنئة والإقرار بما يخالف الإسلام، ولو نظرنا إلى الكلمات التي اعتاد المسلمون عليها عند التهنئة نجد أنها ليس فيها أي إقرار أو موافقة على ما يغاير الإسلام.
- الأدلة على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم:
قوله تعالى: (لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ﮏ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون) [الممتحنة:8، 9] ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم:
فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكريمة برَّهم والإقساط إليهم، والقسط يعني: العدل، والبر يعني: الإحسان والفضل، وهو فوق العدل، فالعدل: أن تأخذ حقك، والبر: أن تتنازل عن بعض حقك. العدل أو القسط: أن تعطي الشخص حقه لا تنقص منه. والبر: أن تزيده على حقه فضلًا وإحسانًا.
وأما الآخرون الذين نهت الآية الأخرى عن موالاتهم، فهم الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم، وأخرجوهم من أوطانهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كما فعلت قريش ومشركو مكة بالرسول ﷺ وأصحابه.
وقد اختار القرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال:(أَن تَبَرُّوهُمْ) وهي الكلمة المستخدمة في أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى، وهو (بر الوالدين)([18]).
قوله سبحانه: (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا) [النساء:86] نحن نشأنا مخالطين لغير المسلمين، وبطبيعة الحال فإنهم عند وجود مناسبة يبادرون بتقديم التهنئة؛ فكيف يكون المسلم سيء العِشرة، فظ الطبع، لا يحسن رد المعروف!
قوله تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة:83] فجاء الأمر بالإحسان لسائر الناس، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما أخرجه الإمام البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة:83] قال: يعني الناس كلهم([19]).
قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5] فقد أجاز القرآن مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج من نسائهم، ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: وجود المودة بين الزوجين؛ كما قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون) [الروم:21] وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيته وشريكة عمره، وأم أولاده؟ وقد قال تعالى في بيان علاقة الأزواج بعضهم ببعض: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [البقرة:187] ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بين الأسرتين، وهي إحدى الرابطتين الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر؛ كما أشار القرآن بقوله: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) [الفرقان:54] ومن لوازم ذلك: وجود الأمومة وما لها من حقوق مؤكدة على ولدها في الإسلام، فهل من البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير عندها ولا يهنئها به؟ وما موقفه من أقاربه من جهة أمه، مثل الجد والجدة، والخال والخالة، وأولاد الأخوال والخالات، وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي القربى، وقد قال تعالى: (وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) [الأنفال:75] وقال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى) [النحل:90] فإذا كان حق الأمومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة الأم والأقارب بما يبين حسن خلق المسلم، ورحابة صدره، ووفاءه لأرحامه فإن الحقوق الأخرى توجب على المسلم أن يظهر بمظهر الإنسان ذي الخلق الحسن([20]).
قول الله تعالى: (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ) [النساء:36] فقد روى الإمام الطبري والإمام ابن أبي حاتم عند تفسيرهما لقوله سبحانه (وَالْجَارِ الْجُنُبِ) قال: «اليهودي والنصراني» وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع: الغريب البعيد مسلمًا كان أو مشركًا يهوديًّا كان أو نصرانيًّا([21]).
قوله عزَّ وجلَّ (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَان) [الرحمن:60] استئناف مقرر لمضمون ما فصل قبله؛ أي: ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب([22])، فلو أن غير المسلم أحسن إلينا وتودد وقام بتهنئتنا في أعيادنا، أليس من البر وحسن العِشرة أن نُحسن إليه كما أحسن إلينا.
المبادئ السامية التي دعا إليها النبي ﷺ حيث فرق عليه الصلاة والسلام بين حسن العِشرة والرقي في المعاملة وبين العقائد، ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أنس- رضي الله عنه- قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»([23])
ومعلوم أن الزيارة أكبر شأنًا وأعظم قدرًا من مجرد التهنئة، بل وكان من هديه ﷺ أن يعظم النفس لكونها نفسًا خلقها الله دون النظر إلى ما تعتقد فقد روى الشيخان عن ابن أبى ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض. فقالا إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل: إنه يهودي. فقال: «أليست نفسًا»([24]) فقد قام النبي ﷺ تعظيمًا لنفس سواها الله بيده، وقام الصحابة من بعده كما علمهم، ولم ينكر أحدهم على الآخر.
جاء في الحديث الشريف عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي ﷺ مع ابنها فاستفتيت النبي ﷺ فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»([25]) هذا وهي مشركة، ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه من المشركين الوثنيين([26]). قال الإمام النووي: راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل: معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه([27]). وفي كلا الحالتين إن كانت راغبة عن الإسلام أو راغبة في مال ابنتها المسلمة فقد أمر سيدنا النبي ﷺ بالإحسان إليها وصلتها.
في الحديث الشريف قبل النبي هدية المرأة اليهودية؛ فقد أهدت زينب بنت الحارث اليهودية- وهي بنت أخي مرحب- شاة مصلية وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حين أخبرت أنها أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله ﷺ، فلما دخل رسول الله ﷺ ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة قدمت إلى رسول الله ﷺ فتناول الكتف والذراع فانتهس منها وتناول بشر عظما آخر... إلخ([28]) فهذه امرأة يهودية أهدت شاة لرسول الله ﷺ وقد قبل منها، وقبول الهدية وأكلها أشد من مجرد التهنئة بكلمة عابرة.
استقبال النبي ﷺ لنصارى نجران ففي الحديث الشريف: لما قدم وفد نجران على رسول الله ﷺ دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فحانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله ﷺ: «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم([29])، وهذا من عظيم رأفته وفيض سماحته ﷺ حيث سمح لغير المسلمين بدخول مسجده الشريف، بل وصلوا فيه في وجوده ﷺ ، ولما أراد الصحابة منعهم من أداء صلاتهم أمرهم النبي ﷺ أن يتركوهم وشأنهم، ومعلوم أن دخول المساجد وخاصة مسجد رسول الله ﷺ والصلاة فيه، بل وفي حضوره ﷺ- أعظم بكثير من مجرد التهنئة القولية، فلا ينبغي التسرع بالحكم دون علم أو ورع وإلقاء تهمة الكفر والشرك على المسلمين جزافًا.
جاء في الأثر عن سيدنا عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-: أنه كان له جار يهودي وكان إذا ذبح الشاة قال: «احملوا إلى جارنا منها»([30])، فلم يمنع كون الرجل يهوديًا أن يحسن إليه سيدنا عبد الله بن عمرو، ويرسل إليه بالهدية تلو الهدية؛ كما تعلم من أخلاق سيدنا رسول الله ﷺ.
الترك ليس بحجة؛ فليس مجرد ترك النبي ﷺ لأمر ما دليلًا على تحريمه، فالأمور التي تركها النبي ﷺ على أنواع، منها هذا النوع الذي معنا وهو أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه ﷺ مشروعًا غير مخالف لسنته، كقتال أبي بكر- رضي الله عنه- لمانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته ﷺ([31]).
نستند أيضًا في جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بالقاعدة الأصولية (العادة محكمة) والعادة كما عرَّفها الهندي: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة([32])، وقد جرت عادة المصريين على التلاحم فيما بينهم، فيتشاركون الفرح والمصاب وهم لُحمة واحدة، ويتبادلون التهنئة دون إقرار على العقائد أو دخول في تفاصيلها؛ فلذلك كان لزامًا علينا الأخذ بهذه القاعدة.
مرَّ معنا في التمهيد أن العصر الذي نعيش فيه اختفى فيه التقسيم الديني للمجتمع وحل بدلًا عنه مفهوم المواطنة، وهو مفهوم لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في شيء، فالمواطنة: مفاعلة بين الإنسان وبين الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه، وهي تقتضي أن يكون انتماء المواطن وولاؤه وحبه لوطنه الذي ينتمي إليه، ويدافع عنه.
وحب الإنسان لوطنه هو حب غريزي يُولد مع الإنسان ذي الفطرة السليمة، وقيل في مأثور الحِكم: «حب الأوطان من الإيمان»، وقيل: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه» ([33]).
ومما يدل على أن المواطنة لا تصادم الدين الإسلامي أن رسول الله ﷺ ترك لنا أربعة نماذج للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها وهي:
الأول: نموذج مكة المكرمة، وكان المقام فيها هو مقام الصبر والتعايش.
الثاني: نموذج بقاء المسلمين في الحبشة، والمقام فيها مقام الوفاء والمشاركة.
الثالث: نموذج المدينة في عهدها الأول، والمقام فيها مقام الانفتاح والتعاون.
الرابع: نموذج المدينة في عهدها الأخير، والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي([34]).
والذي ينطبق عليه مفهوم المواطنة، هو نموذج المدينة في عهدها الأول مما يعني أن المواطنة منسجمة مع أحكام الإسلام ولا تخالفها، ونحن نعيش الآن في مصر وفق المواطنة ما يشبه نموذج المدينة الأول؛ أي: أن المقام فيها مقام الانفتاح والتعاون مع الآخر وليس تنفيره بالفتاوى التي تثير الكراهية والبغضاء.
والذي نريد قوله: إن مصر دولة تقوم على المواطنة، المسلم يتكاتف مع غير المسلم من أجل بناء الوطن، وإعلاء مصلحته، بلا تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون، هذه المواطنة تُعبر عن نفسها على أرض الواقع في مشاركة المواطنين في الشأن العام يشاركون بالرأي والصوت الانتخابي، وممارسة المنصب السياسي، وترتبط هذه المشاركة بعمق انتمائهم للوطن الذي يعيشون فيه، واستعدادهم دائما للعمل على رقيه وتقدمه([35]).
وقد كان المجتمع المصري وما زال على قلب رجل واحد؛ لأنه ينبت من لُحمة واحدة يتشارك المسلمون والمسيحيون في أفراحهم وأتراحهم، يقف المسلم بجوار المسيحي في الفرح والحزن، ويجلس المسيحي بجوار المسلم ليستمع معه إلى كتاب الله، فماذا سيحدث إن فتتنا هذا النسيج ونشرنا الفتاوى التي من شأنها تمزيق لُحمة الوطن؟
بعد أن استعرضنا الأدلة التي بنى عليها المانعون قولهم بالتحريم أو الكفر وفندنا أدلتهم، وذكرنا الأدلة الكافية لتأكيد ما ذهبنا إليه؛ فإننا نطرح بعض الأسئلة وننتظر أن يُجيب عليها العاقل المنصف:
لمصلحة من تتحول مسألة فقهية يمكن أن تمر مرور الكرام إلى مسألة عقدية ويصبح من يفعلها كافرًا؟
كيف لا يمكن اعتبار هذه المسألة من باب تأليف قلوب غير المسلمين، وحسن العشرة بيننا وبينهم؟
كيف سيكون حال وطننا إذا حل الجفاء بين أهله، وأعلن كل طرف القطيعة بناء على فتاوى شاذة؟ هل هي دعوة لتقسيم الوطن بين المسلمين وغير المسلمين؟ أم هي دعوة لإرهاب واضطهاد غير المسلمين؟
كلمات التهنئة التي تجري على ألسنة المصريين على سبيل المثال في كل وقت بمناسبة وغير مناسبة، ما علاقتها بالإقرار على دين غير الإسلام؟ أو ما هو الكفر المترتب عليها؟
كيف ستكون صورة الإسلام في أعين الغرب عندما يعلمون أننا نتناحر فيما بيننا في حكم تهنئة جيراننا، وزملائنا في العمل من غير المسلمين؟ هل هذا سيقربهم من الإسلام، ويغرسه في قلوبهم؟
***