أرشيف الفتاوى
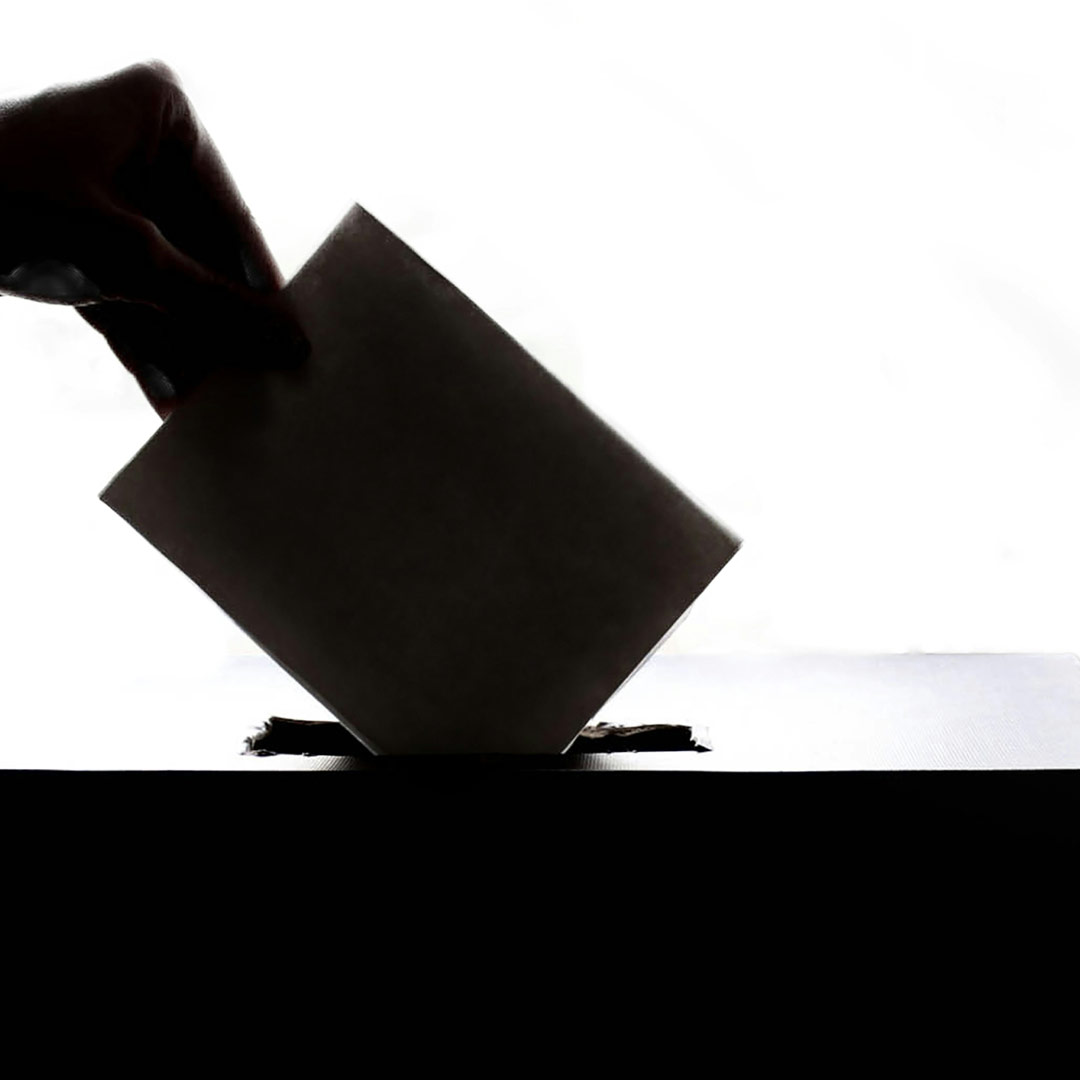

إن من أهم صور المعالجة الفكرية والمنهجية للمفاهيم المشتبكة والمتداخلة هو بيان معاني تلك المصطلحات والمفاهيم، ودلالاتها، والفرق بينها، وعدم خلطها بغيرها؛ لما ينشأ عن ذلك الخلط من قضايا ونتائج تخالف الحقيقة والواقع، وهذا أحد أوجه الفساد الفكري الذي تمارسه المذاهب والآراء التي تفتقد لرؤية منهجية واضحة، أو التي تتعمد خلط المفاهيم سعيًا منها لإحلال مفاهيمها المزيفة في العقل والوعي الجمعي من أجل غاياتها وأهدافها، وهو سمة من السمات الفكرية المشتركة بين الجماعات المتطرفة، وأصحاب الآراء الشاذة، والمشككين في الثوابت الدينية القطعية، وذلك لأنهم جميعًا قد أهملوا المنهج العلمي المنضبط، واقتحموا ساحة العلم بغير قواعد وضوابط.
ومن أبرز المفاهيم التي حصل فيها ذلك التداخل مفهوم النص الديني والخطاب الديني، والفرق بينهما، والمساحة المشتركة التي تجمعهما، وخصائص كل منهما، وموقع كل منهما في المفهوم الديني والعلمي الصحيح، وقد حصل الخلط بين هذين المفهومين بطريقتين متضادتين؛ الطريقة الأولى جعلت الخطاب الديني جزءًا لا يتجزأ من النص، فأكسبت الخطاب خصائص النص، وأجرت عليه قواعد التعامل معه، مع ضرورة لفت النظر إلى أنها قد عبثت أيضًا بمفهوم الخطاب ذاته قبل أن تلبسه لباس النص، والطريقة الثانية أرادت أن تسقط النص، وأن تفقده خصائصه، وأن تجعله مرادفًا للخطاب قابلًا لما يجري عليه، وزعمت أنها بذلك تحرر النص عن قيود أكسبها إياه خطاب ديني له اتجاه فكري مسبق، والحقيقة أن كلا الطرفين قد أخطأ الطريق، وخلط بين معنيين بينهما بون شاسع، فأصبح كلا الفريقين متلبسًا بانعدام المنهج العلمي، وسببًا من أسباب الأزمة الفكرية التي تعيشها الأمة، ومن أجل رفع هذا الالتباس ينبغي علينا أن نقف عند هذين المعنيين بالنظر والتمحيص، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين كل منهما.
إن النص الديني هو حقيقة ثابتة مطلقة، فهو المحور الذي يستند إليه المؤمن في تعامله مع خالقه ومع نفسه ومع الكون كله، فالقرآن والسنة هما الوحي المقدس الذي أرشد الله به المسلمين إلى بناء رؤيتهم ونموذجهم المعرفي، الذي يستلهمون من خلاله المعاني الكلية التي تنطبق على جزئيات الدين والحياة، فهما يمثلان رؤية شاملة وإجابة عن الأسئلة الكبرى حول مبدأ الوجود وغايته، والطريق المستقيم لتحقيق السعادة في الدنيا، وبعد البعث في الآخرة، فنحن أمام خصائص واضحة لهذا المفهوم، تتمثل في أنه مقدس، وأنه ثابت غير متغير، وأنه مطلق غير نسبي، وأنه محور البناء المعرفي للمسلم، وأنه المصدر الأساسي للجواب عن الأسئلة الوجودية وتأسيس المعاني الكلية التي يتبناها الفرد والمجتمع المسلم.
ثم إن هذا المفهوم ينطبق تحديدًا على القرآن الكريم إجمالًا وتفصيلًا من حيث ثبوته ومصدريته، وينطبق على السنة المطهرة إجمالًا من حيث أنها وحي مقدس، لا فرق بينها وبين القرآن إلا من حيث أن ألفاظها من كلام النبي ﷺ وليست من كلام الله سبحانه، لكنها مصدَّقةٌ بكلام الله الذي قال في حق نبيه ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4 ] والفرق الثاني في طريق إثبات كل منهما، حيث إن السنة نقلت بطريق غير طريق التواتر القطعي الذي نقل به القرآن الكريم، فأدى ذلك إلى ثبوت خصائص النص المقدس لها إجمالًا، والتوقف في إثباتها تفصيلًا على حصول الظن بورود الخبر عن رسول الله ﷺ بأدوات الإثبات والتوثيق التي تلقتها الأمة بالقبول.
هذا من حيث خصائص النص الديني وما تنطبق عليه هذه الخصائص، أما من حيث الوظائف؛ فإننا نجد أن الأمة الإسلامية قد أدركت محورية الوحي في تكوينها الفكري والمعرفي، فأنشأت علومها دائرة في فلك الوحي، خادمة له، وأدركت أن قيام النص الديني بوظيفة الإرشاد للمؤمن لا يمكن أن تتم إلا من خلال أدوات معرفية منهجية واضحة، فقامت بصناعة تلك الأدوات وصياغتها من داخل بيئة النص الشرعي، فنحن أمام مركزية للنص الشرعي، ننطلق منه أولًا لبناء الأدوات التي نجده قد أرشدنا إليها، ثم نعود إليه لنستعمل تلك الأدوات في إدراك الحقائق التي يهدينا إليها، وهذه المركزية لا تعني بالضرورة الوقوع في دائرة مغلقة، وإنما هي تفاعل مع النص في كلياته وجزئياته معًا، فإذا ضربنا مثلًا للأدوات المنهجية بضرورة توثيق النص، وفهمه من خلال اللغة التي نزل بها، والوقوف مع القطعيات التي اتفق عليها أهل الإسلام من ضروريات الدين، وغير ذلك من الأدوات، فإننا نجد الإرشاد إلى تلك المعاني واضحًا جليًّا في القرآن والسنة، فهي التي لفتت أنظارنا إلى استعمال تلك الأدوات قبل الإقبال على المعاني الجزئية للوحي الشريف؛ لتتحقق بذلك مركزيته ومصدريته المطلقة.
أما الخطاب الديني فهو يمثل جانب البلاغ في المفهوم الديني، حيث إن هذا الخطاب هو مجموعة الطرق والوسائل والأدوات الفاعلة التي يمكن من خلالها إرساء وترسيخ الفهم الديني المنضبط للنص، فهو عمل مرتبط بالواقع، ومتغيراته الزمانية والمكانية، وأدوات التواصل، وطرق تفعيل المفاهيم الدينية في الحياة، فهو كما يتضح أمر نسبي، يتسم بالمرونة والتغير، ويختلف باختلاف الأدوات والوسائل، ويمكن وصفه بأوصاف متعددة طبقًا لمخرجاته التي ينتجها في الواقع، فقد يكون خطابًا متشددًا يتسم بالجمود والسطحية وعدم إدراك الواقع ومتطلباته، أو خطابًا منحرفًا يهدف إلى التشكيك في النص والمقدسات، والعبث بالمفاهيم، والدعوة إلى نسبية الحقائق، ورفض مركزية الوحي في البناء المعرفي الديني، وقد يكون كذلك خطابًا وسطيًّا يدرك محورية النصوص الشرعية، وكونها أهم مصادر المعرفة، وقداستها في ذاتها من حيث كونها وحيًا إلهيًّا، ولا يغفل مراعاة الواقع الذي يُنزِّل فيه مفاهيم النصوص وأحكامها، ويستثمر أدوات التواصل الفعالة التي تجعل خطابه محققًا لمقصود الشرع من إرشاد المكلفين في دينهم ودنياهم.
إن الخطاب الديني الرشيد يستمد فاعليته كذلك من النص، الذي رسم المبادئ العامة لمناهج بلاغ هذا الدين الحنيف، من حيث كونه دعوة إلى عبودية الله، لا إلى غايات ورغبات ذاتية لأصحاب هذا الخطاب، وأنه يجب أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير ورفع الحرج عن الخلق، والشفقة والرأفة بعباد الله، وغير ذلك من المعاني السامية التي رسمت معالم إرشادية في طريق إبلاغ الرسالة الحنيفية السمحاء.
لقد عاش الخطاب الديني في العقود الأخيرة إن لم يكن طوال القرن الماضي أزمة حقيقية، دفعت كثيرًا من المفكرين وأصحاب الرأي إلى الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، وربما كان ذلك إثر صدمة معرفية أصابت المجتمعات المسلمة بعد اطلاعها على المدنية الغربية، أو ورود كثير من الأفكار الطارئة التي دفعتهم إلى التفكير في مفردات الخطاب الديني المستقر، ومدى تأثيره على حياتهم الواقعية.
ومن هذه اللحظة أصبحت هناك ثلاث توجهات رئيسية في الخطاب الديني، أولها كان خطابًا إصلاحيًّا يدعو إلى الانطلاق من النص، والمحافظة على قداسته ومحوريته، مع إعادة النظر في أدوات الخطاب، وتجديدها، والاشتباك مع الواقع المعاصر في أدواته ومناهجه وقضاياه، ومحاولة إنتاج خطاب ديني مستنير يقوم بوظيفته الإرشادية دون أن يكون منفصلًا عن الحياة الواقعية، وإنما يشكل جزءًا منها عبر الاجتهاد في تطبيق المفاهيم الدينية على الواقع بشكل صحيح.
أما التوجه الثاني فقد كان خطاب أصحابه متشددًا متعنتًا في مسايرة الواقع، يريد أن يحشد الناس لتغيير هذا الواقع دون أن يمتلك منهجًا واضحًا، فسعى إلى ربط الناس ببعض النصوص والمفاهيم الشرعية، والهيئات الظاهرية في الأمور الاجتماعية، وشكل من خلالها خطابًا متكاملًا له خصائصه وسماته، ويمكن تصنيف الناس من خلاله، ثم وضع ذلك الخطاب في موضع النص، وألبسه لباس القداسة، وجعله المرجعية في الحكم على الخلق جميعًا، وسعى بهذا الخطاب إلى تحقيق أغراض ومكاسب طائفية، لا تمت بصلة لغايات الشريعة وأهدافها، واستطاع من خلال ذلك أن يقسم المجتمع ويفتته، ويضرب بعضه ببعض عبر ذلك الخطاب الذي اعتمد على خلق الانفعالات العاطفية والحماسية، والحشد الجماهيري، دون أن يكون له أي قدر من المعقولية أو الحكمة، وهو نمط الخطاب السائد لدى جماعات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية .
وأما التوجه الثالث فقد كان أصحابه الأكثر دعوة إلى تجديد الخطاب الديني، دون أن يحددوا لذلك معنًى واضحًا، أو منهجًا راسخًا، فقد كانت دعواتهم مطلقة، تمارس التشكيك والتلبيس، وتهدف إلى تفريغ الخطاب الديني من مضامينه، ومن وظائفه الإرشادية، وهو ما دفعهم إلى نزع القداسة حتى عن النص الديني، فساروا في اتجاه مضاد للفئة السابقة، فأصبح النص في منظورهم خطابًا محتملًا للنقد، شأنه في ذلك شأن الأعمال الإنسانية، فاقدًا لخصائصه ووظائفه، لا يمثل ضرورة معرفية في تكوين العقل المسلم، ولا تمثل إجاباته عن الأسئلة الوجودية دليلًا قطعيًّا شافيًا، أو هداية للحائرين، وحين فقد النص مركزيته لدى هؤلاء فإن الإنسان في نظرهم قد صار حرًّا عن تلك القيود التي توجهه في حياته، غير عابئين بما ينتج عن ذلك من هدم النموذج المعرفي، وتفكك البناء الأخلاقي، والسيولة في المفاهيم والأفكار والسلوكيات.
إن التوجهات التي أنتجت خطابًا دينيًّا مضطربًا قد فاتتها تلك الحلقة الواصلة بين المفهومين- النص الديني والخطاب الديني- وفَقدُ تلك الحلقة هو الذي سلك بهم تلك المسالك الفاسدة، وهذه الحلقة هي أدوات فهم النص الديني، فإن النص قبل أن يصير خطابًا وبلاغًا للناس لابد أن يمر بمرحلة وسيطة وهي الفهم والإدراك، وهذه أهم المراحل التي تجتمع فيها الأدوات العلمية المنضبطة، والنموذج المعرفي، ومقاصد الشرع، والقواعد والضوابط الثابتة بالاستقراء، ليتركب منها جميعًا منهج متكامل يتعمق في إدراك معاني النص وحقائقه قبل أن يحولها إلى خطاب مؤثر في الواقع، وفي هذه المرحلة أيضًا لا يكتفي بإدراك النص دون أن يدرس الواقع المراد تنزيله فيه دراسة جادة واعية، يستوعب متغيراته ووسائله المستجدة، ويرعى تطبيق النص في إطار مقاصده، وهذا المنهج هو الذي افتقده من يدعو إلى خطاب ديني يجتر فيه الماضي اجترارًا كاملًا، أو يتجاهل فيه التفريق بين العناصر الثابتة والمتغيرة في هذا الخطاب.
إن المخرج من أزمة الانفصال بين الخطاب الديني والواقع لا يكون إلا عبر تلك الرؤية المتكاملة التي تجمع قداسة النص، وأدوات الفهم العميق، وآليات التجديد الحقيقي الذي لا يسعى إلى التغيير أو التزييف، وإنما يسعى إلى حسن البلاغ بصورة لافتة للنظر، وإحياء معاني الدين في النفوس، حتى يكون الخطاب الديني مجليًا لحقائق الدين، وليس أداة تستغل من ذوي الأهواء والضلالات للعبث بأديان الناس، أو زعزعة إيمانهم المستقر وصرفهم عن العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى.