أرشيف الفتاوى
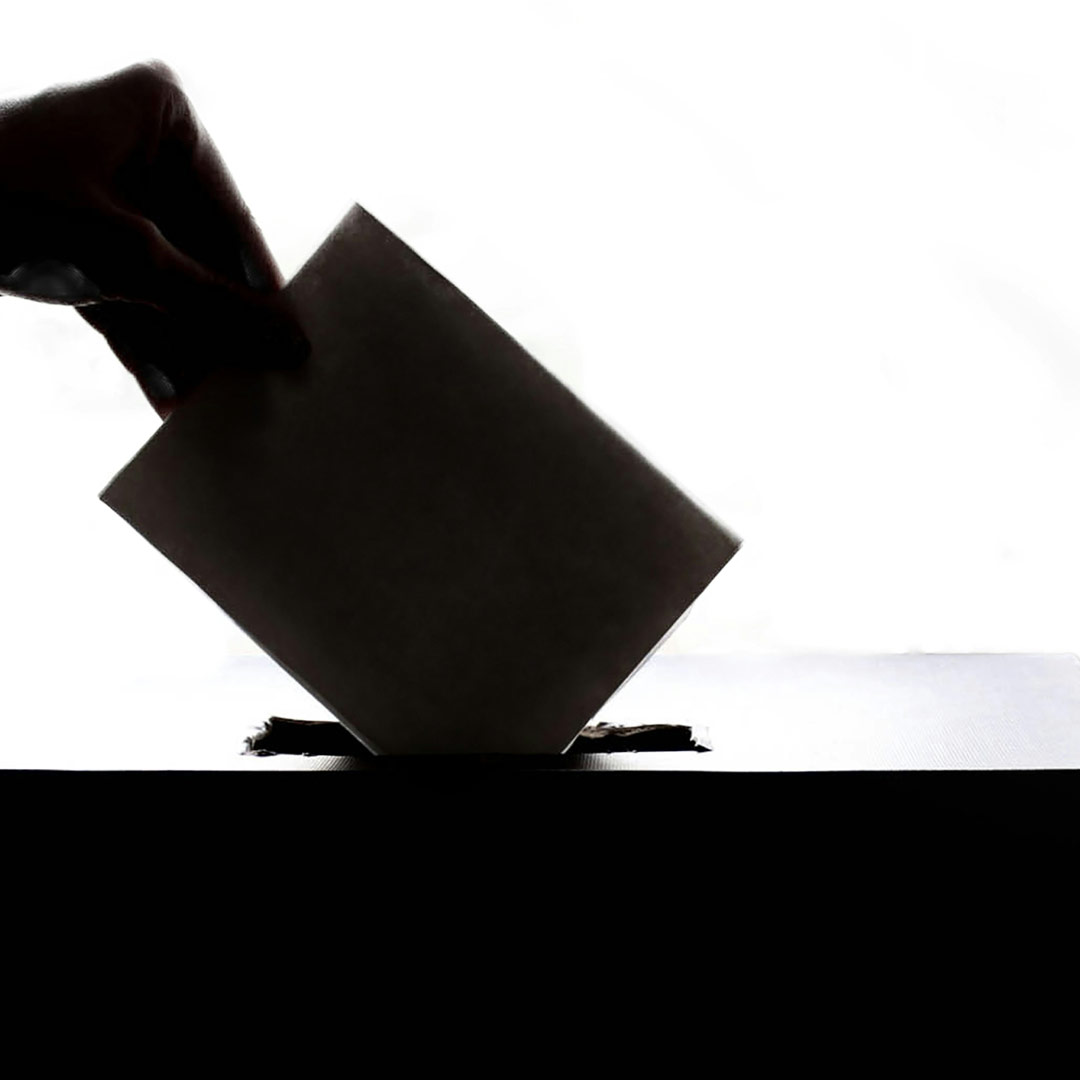

مما اهتم به علماء الأمة الإسلامية على مدى تاريخنا الطويل الممتد لأكثر من ألف وأربعمائة عام فهم العلاقات بين الأشياء، وضعوا لأجل ذلك أسسا راسخة ثابتة في طريق فهم هذه العلاقات والروابط، التي تصل بنا في نهاية المطاف لتحديد ما إذا كانت الأشياء فيما بينها متحدة تمام الاتحاد، أو أحد الأشياء أعم من الآخر فيشمله ويتضمنه، أو أن هذه الأشياء متباينة مختلفة تمام الاختلاف، أو ثمة أرضية مشتركة، فيشتركون في خصائص ويختلفون في أخرى.
سباحةٌ في عالم الأفكار صُقلت بمرور الوقت، أعطت للأمة خصيصة تفردت بها، وكانت عاملًا في تقدمها ركب الحضارة، هذه السباحة الفكرية ألقت بظلالها للاهتمام ليس بعالم الأفكار فقط، بل بعالم الأشياء، والأشخاص والأحداث كذلك.
هذا الاهتمام البالغ بعالم الأفكار وغيره، وهذه الحضارة العظيمة التي لا يمكن أبدا أن تعد طفرة في تاريخ الأمة الإسلامية، تثير سؤالا معتادا في عصرنا الحاضر: هل العلم والاهتمام به في المطلق هو منشأ التقدم والحضارة، أم أن الدين هو كلمة السر والدافع للنظر والتفكر والتدبر والعمل وعمارة الأرض.
ولئن كان هذا السؤال اعتياديا طرحُه في منتديات المثقفين في عصرنا، إلا أنه من الغرابة بمكان إذا طرحته في عصر ما يمكن أن نسميه (عصر التراث الإسلامي) وهي الفترة التي يمكن توثيق انتهائها رسميًّا بوفاة الإمام البرهان الباجوري أو يمكننا مد ذلك العصر إلى الإمام شمس الدين الأنبابيِّ وكلاهما ممن تولى مشيخة الجامع الأزهر الشريف العامر.
وغرابة ذلك السؤال أن الإجابة عليه كأنها تطرح لدى ذلك العقل الممتلئ علما، وتلك النفس المشبعة دينًا، أنك تفرق بين مقولة العلم، ومقولة الدين، فتضع بدورك العلم في كفة، والدين في كفة أخرى، وهنا مكمن الإشكال، وسر الغرابة.
إن التفرقة بين العلم والدين تفرقة مستوردة، ليست من كيس الأمة المحمدية على مدى تاريخها الطويل، فهي من مخلفات الحرب الثقافية التي حمي وطيسها بين مفكري أوروبا في عصر تنويرها ونهضتها لظروف دينية خاصة مرت بها أوروبا أثرت على سلاسة الحالة الفكرية والعلمية آنذاك، مما أوقع خصومة بين المجتمع العلمي من ناحية، ورجال الدين من ناحية أخرى، وطبع في النفس تنافرًا بين مقولتي العلم والدين، وإن جرت عدة محاولات للتوفيق بينهما، وعقد الصلح بين المجتمعين.
حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ما كادت تضع أوزارها حتى انتقلت شرارتها على إثر الاستعمار الثقافي والغزو الفكري في بدايات القرن التاسع عشر المصاحب للاحتلال العسكري لبلادنا العربية والإسلامية، ليُقهر المثقفون والعوام قهرًا على الدخول في حرب أجَّجتها نار الإبهار الذي حققته أوروبا بعد ثورتها الصناعية.
ما الفارق بين العلم والدين؟ في الحقيقة لا فرق عند العقل المسلم إلا في المفهوم، أما في الواقع فهما واحد!
العلمُ سرُّ الحضارة، ومنشأ الرقي، ولغز التقدم الإسلامي في شتى ما يهتم به الكائن البشري فيما يسمى بالعصر الذهبي للأمة الإسلامية، أم أنَّ الدين هو ذلك اللغز وكلمة السر ومنشأ التقدم؟ الإجابة بكل وضوح: كلاهما!
كيف ذلك؟! إذن فلنرجع القهقرى لنبين علاقة الاتحاد التي تلزمنا بتحرير مفاهيم كل من العلم والدين، جريا على قاعدة علمائنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
يُعرِّف الإمام العظيم سلطان المتكلمين فخر الدين الرازي رضي الله عنه الدِّين بأنَّه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخيرات([1]). وهذا التعريف تعريفٌ مشهورٌ متداول بين العلماء، يبين لنا أنَّ الدين عبارة عن قواعد عامة، هذه القواعد العامة لها مصدر أساسيٌّ لا تخرج عنه ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة المشرفة.
لم وضع هذا الدين؟ وضع لتطبيقه، وتفعيله في حياة المكلفين، ولامتثال أوامره ونواهيه، وهو الذي نسميه (التدين) ولذلك هناك فارقٌ بين الدين الذي هو قواعد والتدين الذي هو تطبيق، بعبارة أخرى وضع الدين أولًا ثُمَّ طلب من المكلفين التديُّن ليس ثانيا، بل ثالثًا.
فهناك أولًا دين، وهناك ثالثًا تدين، وهناك مرحلة وسَط بين ذلك الدين العظيم المنثورة قواعده في آي الذكر الحكيم وكلام النبوة المطهر، وبين التطبيق العملي المكلف به المسلم، تلك المرحلة هي مرحلة الفهم، هي مرحلة (العلم).
وهذا المعنى نفهمه من تعريف الإمام البيضاوي لأصول الفقه حيث قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد([2]).
فالعلم أو الفهم هنا مرحلة هامة جدا يقوم بها المتخصصون لفهم ما دل على ذلك الوضع الإلهي، هذا الفهم الذي وضعَ المسلمون لأجله العديد من العلوم والمعارف المبنية على قواعد وأسس راسخة، تصل بنا إلى فهم صحيح سليم للدين، وبالتالي نصل إلى تطبيقه بالصورة المطلوبة، التي تحافظ على مقاصد الشريعة الغراء، من حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال، ويتحقق بها عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس.
وهنا نقطة في غاية الأهمية وهي أن علم الفقه الباحث عن الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين لا يستطيع الفقيه أن يتم مهمته العلمية إلا بإدراك الواقع المتمثل في إدراك الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذه لها علوم خاصة بها خارجة عن دائرة العلوم الشرعية المعهودة، وإن كان الجميع في تلك الحالة يقع ضمن مفهوم العلوم الشرعية، لأنه لا سبيل للعلم بحكم الشرع إلا بإدراكها وتصورها التصور التام النافي للجهالة على قدر الطاقة البشرية، ولذلك يظل العالم في حالة استنفار ليتعلم الواقع ويدركه إدراكا تاما يقول الإمام القرافي:
فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده واجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين([3]).
والناظر في تراثنا الإسلامي العظيم يرى علمًا يلوح في الأفق، ألا وهو علم الكلام، رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق كما يقول السيد الشريف الجرجاني في شرحه على مواقف الإمام عضد الدين الإيجي([4])، وهو أحد أهم مصادر وروافد علم أصول الفقه، قال ابن الحاجب في مختصره: وأما استمداده- أي أصول الفقه- فمن الكلام والعربية والأحكام. وقال التاج السبكي: أما الكلام؛ فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى، وصدق المبلغ، وهو؛ أي صدقه: يتوقف على دلالة المعجزة، وكل ذلك من علم الكلام([5]).
والناظر في هذا العلم يرى أن الدراسات حول الطبيعة وما توصل إليه العلماء في تلك العصور حول الفيزياء وغيرها من علوم الكون مستوفى البحث فيه في الكتب العالية لذلك الفن، ككتب الفخر الرازي والبيضاوي وعضد الملة والدين الإيجي، وسعد الدين التفتازاني، والسيد الشريف الجرجاني رضي الله عنهم أجمعين، ذلك أن موضوع علم الكلام ليس فقط الله جل جلاله وتقدست أسماءه، بل موضوعه على التحقيق متردد بين الموجود أوالمعلوم على الخلاف في ذلك([6]).
كل ذلك دفع العلماء للكلام عن مفهوم العلم على حدة فهمًا لطبيعته وطرق تحصيله والفرق بين الأنواع المختلفة من الإدراك، فأقاموا نظرية معرفة متكاملة واضحة المعالم، وسبقوا العالم الحديث في ذلك.
يقول فضيلة مولانا الدكتور علي جمعة: ويمكن خلال نظرية المعرفة الإسلامية، والتي ترى أن مصادر المعرفة عند المسلم هي: الوحي والوجود معًا حتى شاع التوجيه لقراءة الكتابين: كتاب الله المنظور وكتابه المسطور -أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه أصول الفقه الحضاري، والذى يُضيف إلى أصول الفقه الموروث الخاص بفهم النص (الوحي) ما يمكن أن يكون أداة لمدارسة الواقع، مستفيدين من كل أنواع المناهج التي استخدمت في الماضي، والتحليل في العلوم الاجتماعية والإنسانية بل والكونية، من غير أن نتَّخذ مناهج التلفيق، أو التوفيق، أو القبول المطلق، أو الرفض المطلق، أو الانتقاء العشوائي، بل تكون الاستفادة بإنشاء أداة يتعلَّمها المفتي، ويتمكن بها من إدراك ذلك الواقع الذي أصبح شديد التغير، سريع التبدل بعد هذه الطفرة في المواصلات، والاتصالات، والتقنيات الحديثة، والتي جعلت الإنسان لا يعيش أمسه في يومه، وتفصيل ذلك يحتاج إلى جهود متواصلة ليتم بصورة متأنية تبني ولا تهدم، وتنفع ولا تضر([7]).
ولعل ذلك يجعلنا نتوهم أن العلم أمر غير مقصود بالذات ما كان إلا لفهم الدين وخدمته، أو لكونه المرحلة الوسطى بين الدين والتدين، لكن القرآن وهو حجة الإسلام ناطق بغير ذلك، فالقرآن دال على أن شرف العلم ذاتي، وأن النظر المحصِّل للعلم مقصود لذاته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ﴾ [آل عمران: 190] وقال: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] وقال: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: 17، 18، 19، 20] وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75] وقال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 9] وقال تعالى:﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11].
وقال الله تعالى في سورة فاطر: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28] قدَّم فيها لفظ الجلالةِ المنصوب لحصر الخشية في العلماء، وإن قُرئ شذوذًا كما ذكر البيضاويُّ وغيره في التَّفسير برفع اسم الله ونصب العلماء تعظيما للعلماء ورفعة لقدرهم وتنويها بجلال منصبهم عند الله سبحانه وتعالى([8])، ذلك أنه في مقام الامتنان الأول والأعظم الذي ذكره الله تعالى في سورة الرحمن بقوله: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 1، 2، 3، 4] وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18] فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنَّى بالملائكة وثلَّث بأهل العلم، قال حجة الإسلام الغزالي قدس الله سرَّه: وناهيك بهذا شرفًا وفضلًا وجلًاء ونبلا!([9]).
([1]) انظر: تفسير الرازي (29/ 529) دار إحياء التراث العربي، بيروت. وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/ 21، 22). وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (1/ 103) دار صادر، بيروت.
([2]) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي (ص 7) دار الكتب العلمية، بيروت.
([3]) الفروق للقرافي (1/ 177).
([4]) انظر: شرح المواقف (ص 13).
([5]) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (1/ 251).
([6]) انظر شرح المقاصد للسعد التفتازاني (ص 12).
([7]) أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله (ص 41).
([8]) تفسير البيضاوي (4/ 258).
([9]) إحياء علوم الدين (1/ 5).