أرشيف الفتاوى
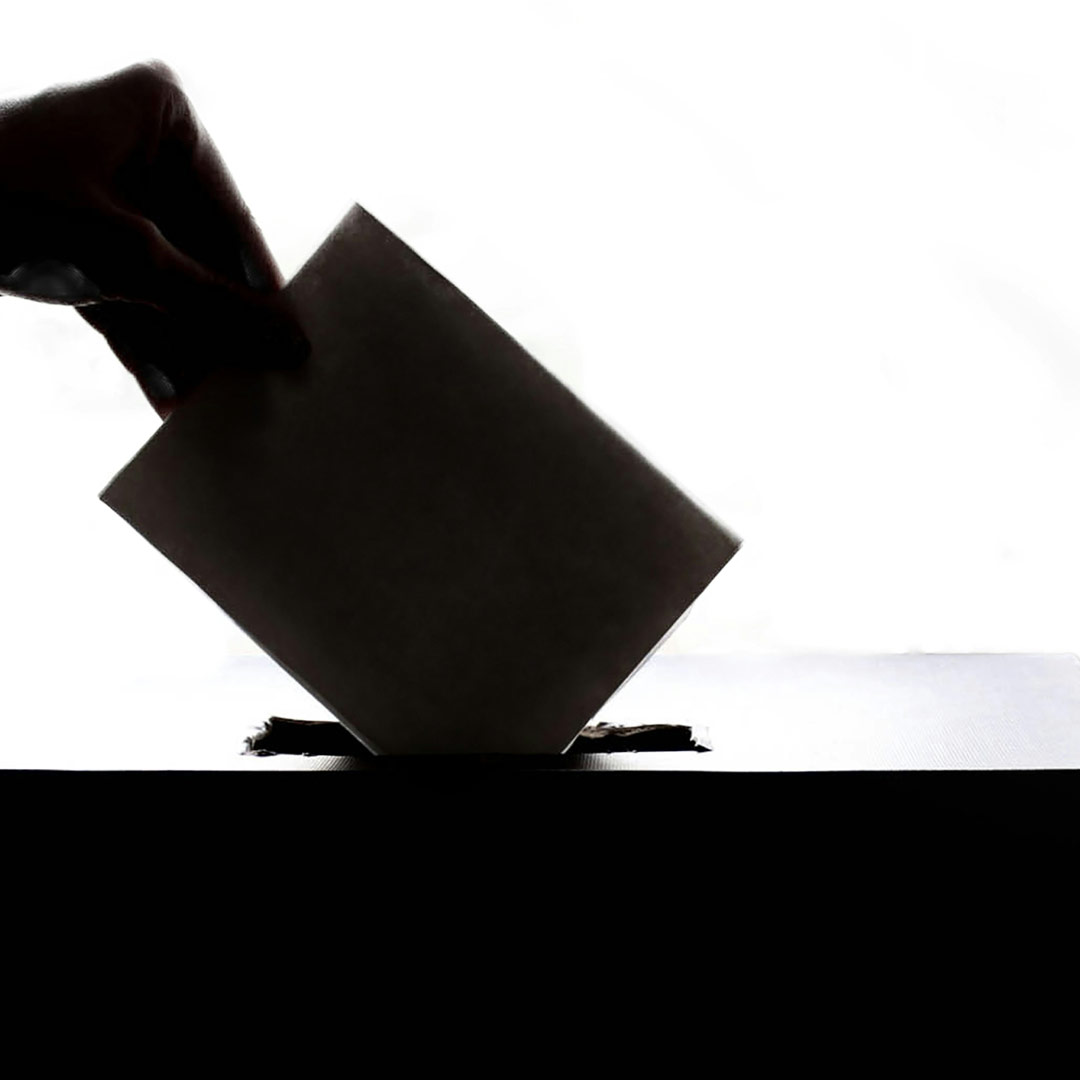

تميزت الشريعة الإسلامية بمفهومها الكلي الشامل الذي انبثق عن معاني وتكليفات كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، جعلت منها مرجعية متكاملة للجنس البشري؛ ومن أهم هذه الخصائص عدم الفصل بين ما تفرضه هذه الشريعة من التكليفات العقدية والتشريعية وبين السلوك الإنساني والتطبيق العملي في حياة الفرد والجماعة، فلم تكن العقيدة ولا معاني الإيمان مجرد سطور في كتاب يحفظه الإنسان أو جمل يرددها؛ بل كانت منهج حياة يتفاعل مع نفس الإنسان وروحه وعقله، يحرك سلوكه ويكوِّن قيمه ومبادئه، ويشكل شخصيته وتتبلور من خلاله أخلاقه.
وقد ظهرت ملامح هذه الحقيقة في معالم رئيسة مؤكدة لها؛ فمن هذه المعالم:
إعلان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن منطلقات رسالته المكلف بها من رب العالمين من خلال نص نبوي جامع شامل لجميع فضائل الدنيا والآخرة؛ فيقول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»([1]).
فجعلت الشريعة الإسلامية سلوك الإنسان وقيمه وأخلاقه جزءًا من العقيدة الإسلامية التي يحاسب عليها، واعتبرت سلوكه مظهرًا من مظاهر إيمانه واعتقاده يكمُل بكماله وينقصُ بنقصانه، فلا ينفصل الإيمان والاعتقاد عن السلوك بحيث يرتبط الإيمان ومعانيه وتجلياته بأوقات أو أماكن أو شعائر محدودة، فيصبح مجرد صور وهيئات؛ بل أوجبت الشريعة الإسلامية أن تكون الأعمال والسلوكيات ترجمانًا لمعاني الإيمان؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»([2]) وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانحراف السلوكي وتجاوز الحد الشرعي الأخلاقي علامة على عدم اكتمال الإيمان؛ ومن أمثلة بيان ذلك في سنته الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم: «واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يُؤْمِنُ، واللهِ لا يُؤْمِنُ. قيلَ: ومَن يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: الذي لا يَأْمَنُ جارُهُ بوائقه»([3]).
والإيمان بالله عز وجل وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته وخلقه وتدبيره لأمر السموات والأرض كعقيدة إسلامية له الأثر الأكبر في قيم الإنسان وسلوكه وأخلاقه، فمنظومة أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة وصفاته ومعانيها وتجلياتها في الكون ومقاديره، ترتبط ارتباطًا كاملًا بسلوك المسلم؛ من حيث تأثيرها في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره وموقفه من تفاعلات حياته الشخصية والمجتمعية، فمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية يتولد منها منهج متكامل للقيم والأخلاق، عندما يلاحظها الإنسان ويتفكر فيها ويطبقها ويتفاعل معها، فتصبح بعد ذلك خلقًا مستدامًا وأسلوب حياة له.
وعلى سبيل المثال فقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد:3] يستخرج منه المسلم الكثير والكثير من القواعد الكلية التي تحكم قيمه وأخلاقه وسلوكه في هذه الحياة الدنيا.
فمن خلال العقيدة والتدين الصحيح، يظهر السلوك القويم من الفرد المسلم، وتظهر الأخلاق في حياته الفردية والجماعية؛ تجاه أسرته وعمله ودراسته وأهداف حياته، وقضايا وطنه وانتمائه لبلده، ويعرف كيف يواجه ويتفاعل مع القضايا الفكرية المعاصرة، وتمثل له حصانة من الانجراف وراء التيارات المنحرفة التي جعلت من الدين المقدس وسيلة لتحصيل المكاسب الدنيوية أو الأهداف السياسية.
فالمسلم من خلال المنظور العقدي الصحيح يرى الله سبحانه ومظاهر قدرته وتدبيره وقهره ورحمته ورأفته قبل الأشياء والأحداث وفي أثناء ذلك وبعده، ويتفاعل مع هذه المعاني الربانية، فلا يستطيع أن ينحرف عن معانيها، فهو يؤمن بالقدر والمقادير ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيشعر بالرضا ويستقر في نفسه أن ما قدر له سوف يصله فتختفي مظاهر التكالب على الدنيا، وتجاوُز الشرع لتحقيق المكتسبات الشخصية.
كذلك فإن الإيمان بالأنبياء والرسل وما أرسلهم الله سبحانه وتعالى به من المنهج القويم يعتبر المثال الأسمى الذي يحتذى به في مجال السلوك والقيم، ويجنب الإنسان التأثر بالنظريات القيمية الفردية التي تنبع من تجارب شخصية لأناس يزعمون قيادة المجتمعات من خلال أطروحات فكرية مجردة عن الوحي الإلهي الذي يصلح أمر الدين والدنيا ويرعى مصالح الناس.
وإذا نظرنا إلى معاني الإيمان باليوم الآخر وأثرها في تقويم السلوك الإنساني فإننا نجد لها أكبر الآثار الإيجابية في هذا المعنى، فيعلم المرء أن هناك حسابًا وسؤالًا من الله عز وجل عن كل كبيرة وصغيرة، وأن هناك ثوابًا وعقابًا وتقييمًا إلهيًا لحياة الإنسان على هذه الأرض.
وكذلك تؤثر العقيدة الصحيحة ومعانيها في مجال العلاقة مع الآخر ورعاية الرابطة الإنسانية، فعندما يسلِّم الفرد المسلم بوحدانية الخالق عز وجل ويرى الخلق جميعا عبادًا لربهم عز وجل، تظهر في سلوكه رؤية ورعاية المشترك الإنساني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في نفوس البشر من معاني التسامح والرأفة والتعاون مع جميع خلق الله، بصرف النظر عن دينه وعرقه ولونه، عملًا بالدستور النبوي الشريف «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلا بِالتَّقْوَى»([4]). وقوله صلى الله عليه وسلم: «الناسُ كلُّهُمْ بَنُو آدمَ وآدَمُ خُلِقَ من تُرَابٍ»([5]).
وقد أدرك هذه الحقائق علماء الإسلام فجاءت أقوالهم شارحة ومبينة لأثر العقيدة الإسلامية في سلوك الإنسان، بحيث يصبح سلوكه جزءً من إيمانه ودينه؛ يقول الإمام الشيخ العز بن عبد السلام: «ومعظم أي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة، وأخلاق جميلة، جعلها الله نصائح لخلقه مقربات إليه مزلفات لديه رحمة لعباده، فطوبى لمن تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاقه الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن»([6]).
ويتميز السلوك الإنساني المتولد عن معاني العقيدة والتدين الصحيح بعدة سمات منها:
- عدم الانفصال النظري أو العملي بين معاني العقيدة الصحيحة والسلوك الإنساني.
- الإلزام الشرعي والالتزام في باب السلوك والتعامل على جميع المستويات الخاصة والعامة، والمراقبة الشخصية لمعاني الأخلاق وتطبيقها، ولو لم يكن عليه رقابة بشرية، فالإنسان ينظر إلى القانون الإلهي ورقابة الله عز وجل في المقام الأول، فغاية السلوك المرتبط بالعقيدة تحقيق مرضاة الله عز وجل، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
- الثبات وعدم التغير، أو القول بنسبية الأخلاق والقيم تبعًا للظروف والمصالح، فمرجعية السلوك البشري المبني على العقيدة ربانية ثابتة راسخة مستقرة تتناسب مع كافة الأزمنة والأماكن والمجتمعات.
- تقديم المصلحة العامة على الخاصة في مجال السلوك الأخلاقي المتولد عن العقيدة الصحيحة والتدين المنضبط.
- عدم التعارض بين أي جزئية من العقيدة وأي مظهر أخلاقي أو قيمي من حيث المنطلقات أو الأهداف أو التطبيق العملي، وما يمثله ذلك من التكامل الذي لا يوجد في أي نظام آخر.
- الشمولية ومراعاة كل الكليات والجزئيات والفرعيات السلوكية من خلال المنظور العقدي؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس والحياء شعبة من شعب الإيمان»([7]).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»([8]).
وقوله صلوات الله وسلامه عليه وآله: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»([9]).
- ظهور معاني الرحمة والسماحة والرفق وجميع سمات الفطرة الإنسانية السليمة في السلوك الإنساني، ورعاية التكريم الإلهي للجنس البشري كله.
- الاستجابة السلوكية لدى الإنسان في استقامة أقواله وأفعاله تكون أكثر إيجابية عندما تنطلق من القاعدة العقدية؛ فعندما حرمت الخمر في المدينة المنورة تمت الاستجابة الفورية من المسلمين في يسر وسهولة دون معارضة، وكذلك كل أمر ونهي أو ترغيب أو ترهيب جاء في القرآن والسنة كان يتم التعامل معه من خلال المنظور العقدي كأمر إلهي لا جدال فيه.
وبالنظر لما سبق يتبين لنا مدى الآثار السلبية التي تصيب الأفراد والمجتمعات عند محاولة فصل السلوك الفردي والمجتمعي عن الإيمان والعقيدة والغيب، ففي عالمنا المعاصر يغيب البعد العقدي الصحيح عن سلوك قطاعات عريضة من المجتمعات والأفراد، ونتج عن ذلك الكثير من الانحرافات السلوكية الفردية والمجتمعية، وانتشار المادية الجافة والتفكك الأسري، وتفشي مظاهر الشذوذ والعنصرية ونشر الكراهية، وشيوع الحيرة وعدم الاستقرار النفسي والطمأنينة، واختفاء معاني المحبة والتسامح، والشعور بالتعالي على أصناف البشر، وما يتبع ذلك من عدم احترام الدماء واستباحة ثروات الأمم والاعتداء تحت مسميات مختلفة قائمة على الخداع وتغيير المفاهيم.
وفي النهاية إذا أردنا أن نحقق معاني السلوك القويم الذي يقربنا من رب العالمين، في نموذج متكامل يجتمع فيه الاعتقاد الصحيح مع حسن السلوك؛ فما علينا إلا السير وراء المثال الأسمى والإنسان الكامل سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه ربه العظيم فقال في حق جنابه الشريف: ﴿وإِنك لَعلَى خُلُق عظيم﴾ [القلم: 4].
([1]) أخرجه أحمد في مسنده (2/381)، والبخاري في الأدب المفرد (273)، والبزار في مسنده (8949)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4432)، والحاكم في مستدركه (2/613)، والبيهقي في الكبرى (10/191) من طريق عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة t به مرفوعًا، وبعضهم يقول فيه أيضًا: «صالح الأخلاق». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 343): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».
([2]) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4682) والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1162) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «حسن صحيح».
([3]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (6016) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار (46) من حديث أبي شريح العدوي .
([4]) أخرجه ابن المبارك في مسنده (ص146) وأحمد في مسنده (5/411) من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم به مرفوعا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/586): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقد ورد التصريح باسم الصحابي عند أبي نعيم في حلية الأولياء (3/100) والبيهقي في شعب الإيمان (7/132) من طريق شيبة أبي قلابة القيسي عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه به مرفوعا.
([5]) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة (3955) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([6]) انظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص284) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، المحقق: رضوان مختار بن غربية - دار البشائر الإسلامية – بيروت - الطبعة: الأولى، 1407هـ - 1987م.
([7]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان (35) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
([8]) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (6018) ومسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف (47) من حديث أبي هريرة.
([9]) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في حسن الخلق (4799) والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق (2002) من حديث أبي الدرداء، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .